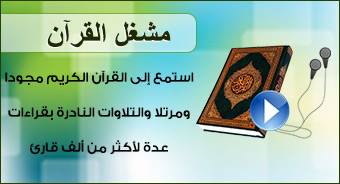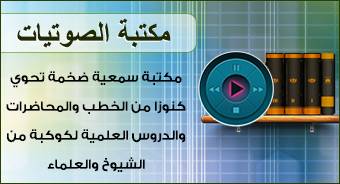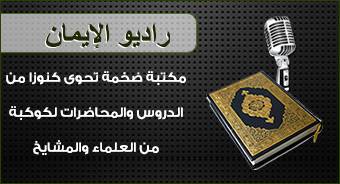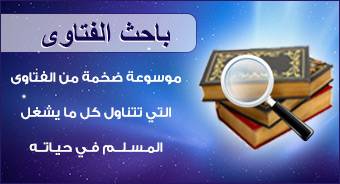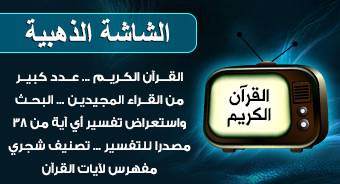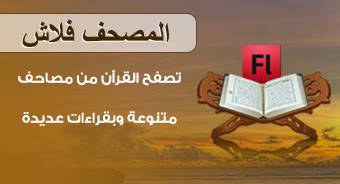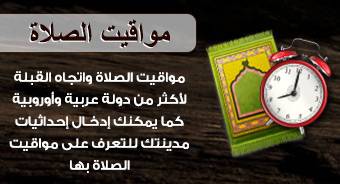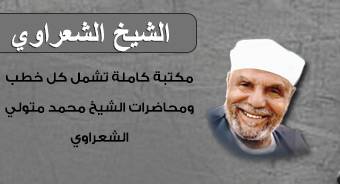|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
والذعلبة: الناقة السريعة، وانتصاب {هلوعا} و{جزوعا} و{منوعا} على أنها أحوال مقدّرة، أو محققة؛ لكونها طبائع جبل الإنسان عليها، والظرفان معمولان لـ: {جزوعا} و{منوعا}.{إِلاّ المصلين} أي: المقيمين للصلاة وقيل: المراد بهم أهل التوحيد يعني: أنهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع؛ وأنهم على صفات محمودة وخلال مرضية؛ لأن إيمانهم وما تمسكوا به من التوحيد ودين الحق يزجرهم عن الاتصاف بتلك الصفات، ويحملهم على الاتصاف بصفات الخير.ثم بيّنهم سبحانه فقال: {الذين هُمْ على صلاتِهِمْ دائِمُون} أي: لا يشغلهم عنها شاغل، ولا يصرفهم عنها صارف، وليس المراد بالدوام أنهم يصلون أبدا.قال الزجاج: هم الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة، وقال الحسن، وابن جريج: هو التطوع منها.قال النخعي: المراد بـ: {المصلين} الذين يؤدّون الصلاة المكتوبة.وقيل: الذين يصلونها لوقتها، والمراد بالآية جميع المؤمنين، وقيل: الصحابة خاصة، ولا وجه لهذا التخصيص لاتصاف كل مؤمن بأنه من المصلين.{والذين في أموالهم حقٌّ مّعْلُومٌ} قال قتادة، ومحمد بن سيرين: المراد الزكاة المفروضة.وقال مجاهد: سوى الزكاة.وقيل: صلة الرحم، والظاهر أنه الزكاة لوصفه بكونه معلوما، ولجعله قرينا للصلاة، وقد تقدّم تفسير السائل والمحروم في سورة الذاريات مستوفى.{والذين يُصدّقُون بِيوْمِ الدين} أي: بيوم الجزاء، وهو يوم القيامة لا يشكون فيه ولا يجحدونه.وقيل: يصدّقونه بأعمالهم، فيتعبون أنفسهم في الطاعات {والذين هُم مّنْ عذابِ ربّهِم مُّشْفِقُون} أي: خائفون وجلون مع ما لهم من أعمال الطاعة استحقارا لأعمالهم، واعترافا بما يجب لله سبحانه عليهم.وجملة: {إِنّ عذاب ربّهِمْ غيْرُ مأْمُونٍ} مقرّرة لمضمون ما قبلها مبينة أن ذلك مما لا ينبغي أن يأمنه أحد، وأن حق كل أحد أن يخافه.{والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون} إلى قوله: {فأُوْلئِك هُمُ العادون} قد تقدم تفسيره في سورة المؤمنين مستوفى.{والذين هُمْ لاماناتهم وعهْدِهِمْ راعون} أي: لا يخلون بشيء من الأمانات التي يؤتمنون عليها، ولا ينقضون شيئا من العهود التي يعقدونها على أنفسهم.قرأ الجمهور: {لأماناتهم} بالجمع، وقرأ ابن كثير، وابن محيصن {لأمانتهم} بالإفراد، والمراد: الجنس: {والّذِين هُمْ بشهاداتهم قائِمُون} أي: يقيمونها على من كانت عليه من قريب أو بعيد، أو رفيع أو وضيع، ولا يكتمونها ولا يغيرونها، وقد تقدّم القول في الشهادة في سورة البقرة، قرأ الجمهور: {بشهادتهم} بالإفراد.وقرأ حفص، ويعقوب وهي رواية عن ابن كثير بالجمع.قال الواحدي: والإفراد أولى لأنه مصدر، ومن جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات.قال الفرّاء: ويدل على قراءة التوحيد قوله تعالى: {وأقِيمُواْ الشهادة لِلّهِ} [الطلاق: 2].{والّذِين هُمْ على صلاتِهِمْ يُحافِظُون} أي: على أذكارها وأركانها وشرائطها، لا يخلون بشيء من ذلك.قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها.وقال ابن جريج: المراد التطوّع، وكرر ذكر الصلاة لاختلاف ما وصفهم به أوّلا، وما وصفهم به ثانيا، فإن معنى الدوام: هو أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغل، كما سلف؛ ومعنى المحافظة: أن يراعي الأمور التي لا تكون صلاة بدونها وقيل: المراد يحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما يحبطها ويبطل ثوابها، وكرّر الموصولات للدلالة على أن كل وصف من تلك الأوصاف لجلالته يستحقّ أن يستقلّ بموصوف منفرد، والإشارة بقوله: {أولئك} إلى الموصوفين بتلك الصفات {فِى جنات مُّكْرمُون} أي: مستقرّون فيها، مكرمون بأنواع الكرامات، وخبر المبتدأ قوله: {فِي جنات}، وقوله: {مُّكْرمُون} خبر آخر، ويجوز أن يكون الخبر مكرمون، و{في جنات} متعلق به.{فمالِ الّذِين كفرُواْ قِبلك مُهْطِعِين} أي: أيّ شيء لهم حواليك مسرعين، قال الأخفش: {مهطعين} مسرعين، ومنه قول الشاعر: وقيل: المعنى: ما بالهم يسرعون إليك يجلسون حواليك، ولا يعملون بما تأمرهم؟ وقيل: ما بالهم مسرعين إلى التكذيب.وقيل: ما بال الذين كفروا يسرعون إلى السماع إليك، فيكذبونك ويستهزئون بك.وقال الكلبي: إن معنى {مُهْطِعِين}: ناظرين إليك.وقال قتادة: عامدين.وقيل: مسرعين إليك مادّي أعناقهم مديمي النظر إليك.{عنِ اليمين وعنِ الشمال عِزِين} أي: عن يمين النبيّ صلى الله عليه وسلم وعن شماله جماعات متفرقة، وعزين جمع عزة، وهي العصبة من الناس، ومنه قول الشاعر: وقال الراعي: وقال عنترة: وقيل: أصلها عزوة من العزو؛ كأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى.قال في الصحاح: والعزة: الفرقة من الناس، والهاء عوض من التاء، والجمع عزى وعزون، وقوله: {عنِ اليمين وعنِ الشمال} متعلق بعزين، أو بمهطعين.{أيطْمعُ كُلُّ امرئ مّنْهُمْ أن يُدْخل جنّة نعِيمٍ} قال المفسرون: كان المشركون يقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنّ قبلهم، فنزلت الآية.قرأ الجمهور: {أن يدخل} مبنيا للمفعول، وقرأ الحسن، وزيد بن عليّ، وطلحة بن مصرف، والأعرج، ويحيى بن يعمر، وأبو رجاء، وعاصم في رواية عنه على البناء للفاعل.ثم ردّ الله سبحانه عليهم فقال: {كلاّ إِنّا خلقناهم مّمّا يعْلمُون} أي: من القذر الذين يعلمون به، فلا ينبغي لهم هذا التكبر.وقيل المعنى: إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون، وهو امتثال الأمر والنهي، وتعريضهم للثواب والعقاب، كما في قوله: {وما خلقْتُ الجن والإنس إِلاّ لِيعْبُدُونِ} [الذاريات: 59]، ومنه قول الأعشى: وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الهلوع، فقال: هو كما قال الله: {إِذا مسّهُ الشر جزُوعا وإِذا مسّهُ الخير منُوعا}.وأخرج ابن المنذر عنه: {هلُوعا} قال: الشره.وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود: {الذين هُمْ على صلاتِهِمْ دائِمُون} قال: على مواقيتها.وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن عمران بن حصين: {الذين هُمْ على صلاتِهِمْ دائِمُون} قال: الذي لا يلتفت في صلاته.وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن عقبة بن عامر {الذين هُمْ على صلاتِهِمْ دائِمُون} قال: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا.وأخرج ابن المنذر من طريق أخرى عنه نحوه.وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {فمالِ الّذِين كفرُواْ قِبلك مُهْطِعِين} قال: ينظرون {عنِ اليمين وعنِ الشمال عِزِين} قال: العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به.وأخرج مسلم، وغيره عن جابر قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ونحن حلق متفرقون فقال: «ما لي أراكم عزين» وأخرج أحمد، وابن ماجه، وابن سعد، وابن أبي عاصم، والباوردي، وابن قانع، والحاكم، والبيهقي في الشعب، والضياء عن بشر بن جحاش قال: «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {فمالِ الّذِين كفرُواْ قِبلك مُهْطِعِين} إلى قوله: {كلاّ إِنّا خلقناهم مّمّا يعْلمُون}، ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه، ووضع عليها أصبعه، وقال: يقول الله: ابن آدم، أنى تعجزني، وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سوّيتك وعدّلتك مشيت بين بردين، وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أو أتى أوان الصدقة».قوله: {فلا أُقْسِمُ}(لا) زائدة كما تقدّم قريبا، والمعنى: فأقسم {بِربّ المشارق والمغارب} يعني: مشرق كل يوم من أيام السنة ومغربه.قرأ الجمهور: {المشارق والمغارب} بالجمع، وقرأ أبو حيوة، وابن محيصن، وحميد بالإفراد.{إِنّا لقادرون على أن نُّبدّل خيْرا مّنْهُمْ} أي: على أن نخلق أمثل منهم، وأطوع لله حين عصوه ونهلك هؤلاء.{وما نحْنُ بِمسْبُوقِين} أي: بمغلوبين إن أردنا ذلك بل نفعل ما أردنا لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر؛ ولكن مشيئتنا وسابق علمنا اقتضيا تأخير عقوبة هؤلاء، وعدم تبديلهم بخلق آخر.{فذرْهُمْ يخُوضُواْ ويلْعبُواْ} أي: اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم، واشتغل بما أمرت به ولا يعظمنّ عليك ما هم فيه، فليس عليك إلاّ البلاغ {حتى يلاقوا يوْمهُمُ الذي يُوعدُون} وهو يوم القيامة، وهذه الآية منسوخة بآية السيف.قرأ الجمهور: {يلاقوا}.وقرأ أبو جعفر، وابن محيصن، وحميد، ومجاهد: {حتى يلقوا} {يوْم يخْرُجُون مِن الأجداث سِراعا} يوم بدل من يومهم، وسراعا منتصب على الحال من ضمير يخرجون، قرأ الجمهور {يخرجون} على البناء للفاعل.وقرأ السلمي، والأعمش، والمغيرة، وعاصم في رواية على البناء للمفعول، والأجداث جمع جدث، وهو القبر {كأنّهُمْ إلى نُصُبٍ يُوفِضُون} قرأ الجمهور: {نصب} بفتح النون وسكون الصاد.وقرأ ابن عامر، وحفص بضم النون والصاد، وقرأ عمرو بن ميمون، وأبو رجاء بضم النون وإسكان الصاد.قال في الصحاح: والنصب ما نصب فعبد من دون الله، وكذا النصب بالضم، وقد يحرّك.قال الأعشى: والجمع الأنصاب.وقال الأخفش، والفراء: النصب جمع النصب، مثل رهن ورهن، والأنصاب جمع النصب فهو جمع الجمع.وقيل: النصب جمع نصاب، وهو حجر أو صنم يذبح عليه، ومنه قوله: {وما ذُبِح على النصب} [المائدة: 3].وقال النحاس: نصب ونصب بمعنى واحد.وقيل: معنى {إلى نُصُبٍ}: إلى غاية، وهي التي تنصب إليها بصرك، وقال الكلبي: إلى شيء منصوب علم أو راية أي: كأنهم إلى علم يدعون إليه، أو راية تنصب لهم يوفضون، قال الحسن: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون الله لا يلوي أوّلهم على آخرهم.وقال أبو عمرو: النصب شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته.ومعنى يوفضون: يسرعون، والإيفاض الإسراع.يقال: أوفض إيفاضا، أي: أسرع إسراعا، ومنه قول الشاعر: وعبقر: قرية من قرى الجن، كما تزعم العرب، ومنه قول لبيد:كهول وشبان كجنة عبقر ** وانتصاب {خاشعة أبصارهم} على الحال من ضمير يوفضون، وأبصارهم مرتفعة به، والخشوع الذلة والخضوع، أي: لا يرفعونها لما يتوقعونه من العذاب {ترْهقُهُمْ ذِلّةٌ} أي: تغشاهم ذلة شديدة.قال قتادة هي: سواد الوجوه، ومنه غلام مراهق: إذا غشيه الاحتلام، يقال: رهقه بالكسر يرهقه رهقا، أي: غشيه، ومثل هذا قوله: {ولا يرْهقُ وُجُوههُمْ قترٌ ولا ذِلّةٌ} [يونس: 26] والإشارة بقوله: {ذلك} إلى ما تقدّم ذكره.وهو مبتدأ وخبره: {اليوم الذي كانُواْ يُوعدُون} أي: الذي كانوا يوعدونه في الدنيا على ألسنة الرسل قد حاق بهم وحضر، ووقع بهم من عذابه ما وعدهم الله به، وإن كان مستقبلا، فهو في حكم الذي قد وقع لتحقق وقوعه.وقد أخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {فلا أُقْسِمُ بِربّ المشارق والمغارب} قال: للشمس كل يوم مطلع تطلع فيه، ومغرب تغرب فيه غير مطلعها بالأمس وغير مغربها بالأمس.وأخرج ابن جرير عنه: {إلى نُصُبٍ يُوفِضُون} قال: إلى علم يستبقون. اهـ.
|